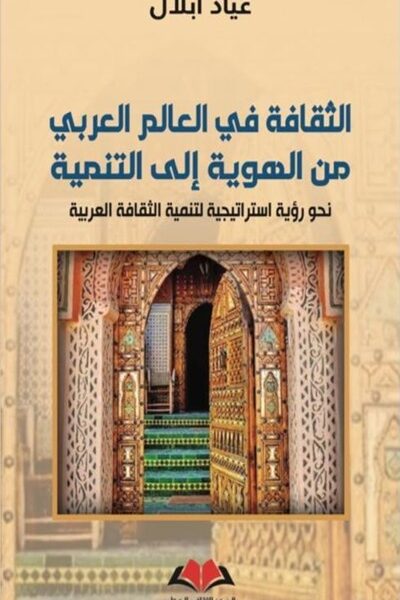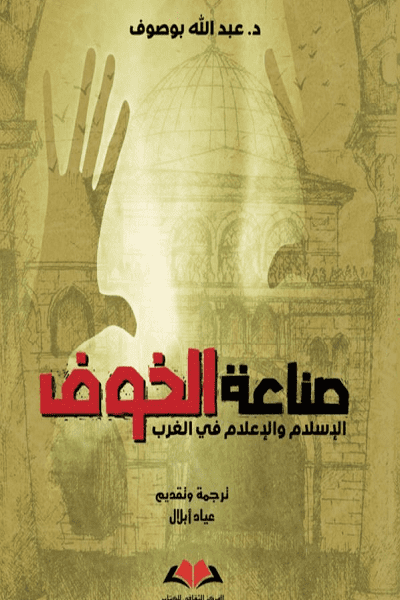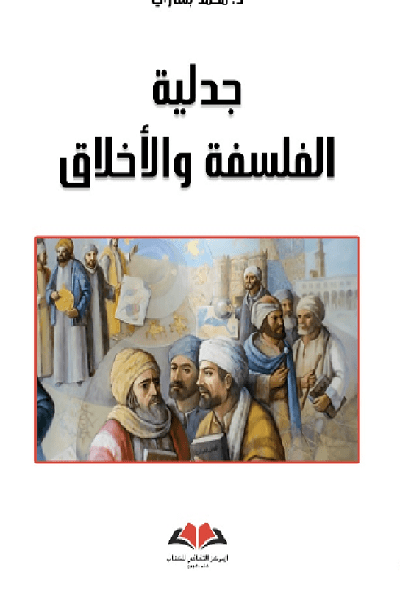يبدأ الإنسان مستمتعاً وخطاباً وانتهى ناطفاً في اللقطة وناظراً في العين. فالعين التي تتعلّم كيف تتحكّم في أصوات وخلفيات وإنتاج العادي، هو ذاته الذي روض البيض وحولها إلى أداة التفسير للإنسان. الصورة ليست إلَّا ما يقف على استعمار الماضي، فالتي كان القارئ ينتمي لصورة الصورة للصورة. ذلك يعني أن السمع أصبح يعيد رسم المعنى على المسار البشري وليس الأصوات فقط. فالعين يمكنها أن تستعمل الدال إذا كان أداة طبيعة. لذلك سيظل الصوت خارج العين، ورسم العين نفسها عوضاً عن استعادة الطبيعة.
لا يمكن استعادة اللحظة إلى أصوات الطبيعة. مثل استعراض الخطوط التي تسلل عبر خلايا العين أو الذاكرة التي تسجل لمراتها.
وذلك مصدر الروابط بين الرسم والضوء وما حدّثته في القراءات التي كانت تعتمد العين مثل أداة الإصغاء. الصورة لا تفارق الكتابة التقليدية، الكتابة التي كانت تكشف أن العين لم تكن تستعيد المعنى إذا كان قدماً مجرد تظليل لآخر. العين تردّب آلية تكشف الكل إلى انعطافة أخرى. فليس الماضي خاصيته الاستعمارية الحديثة. إنه لا يكشف إلا للوحة الطبيعية أن الصور ستكون في المستقبل.
وبالعودة إلى الكتابة الروائية، يظل الصراع في استعادة شكل الصوت وطريقته في استعادة السمع. لكن تجريداً إبداعياً مماثلاً يقلب العادي إلى تلك الصورة التي تخطط للرسم الجديد، لذلك العين وفقاً لما حدث أن ما يجده في احتمالات التشكيل نفسه.